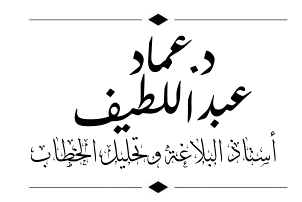تقديم د. عماد عبد اللطيف

نبذة تعريفية عن مقدم الكتاب:
د. عماد عبد اللطيف، أستاذ البلاغة وتحليل الخطاب بجامعة القاهرة وجامعة قطر.
دَرَس في جامعة القاهرة، وجامعة لانكستر البريطانية. كما دُعي باحثًا زائرا في جامعة كمبريدج البريطانية وجامعة طوكيو اليابانية.
والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
يحظى الدكتور عماد عبد اللطيف بتقدير غربي بفضل كتاباته المتعددة باللغة الإنجليزية.
يظهر هذا التقدير في اختياره في عضوية هيئات تحرير مجلات علمية غربية عريقة، مثل:
مجلة الرابطة الأمريكية لمدرسي العربية، التي تصدر عن جامعة جورجتاون، ومجلة اللغة والتربية التي تصدر من سنغافوره. كما يظهر في اختياره شريكًا في مشاريع بحثية غربية، وفي إعداد مؤتمرات دولية غربية.
علاوة على ذلك، فقد نشر مقالات محكمة، وفصول كتب، ومداخل موسوعية في كبرى دور النشر الغربية مثل:
دار نشر جامعة أكسفورد البريطانية، ودار نشر روتليدج الأمريكية، ودار نشر جون بنجامين الهولندية، ودار نشر جامعة ليدن الهولندية، ودار نشر بريل الهولندية، ودار نشر لو هارماتان الفرنسية، وغيرها. كما أسس شراكات بحثية مع باحثين ينتمون إلى بعض من كبرى الجامعات الغربية، وحصل على دعم بحثي من مؤسسات مرموقة مثل الصندوق النرويجي لدعم البحوث، ومؤسسة إرازموس، وجامعة أوسلو، وغيرها.
حصل الدكتور عماد عبد اللطيف على جائزة المهاجر العالمية للفكر والآداب والفنون (استراليا، 2011) عن بحث “البلاغة الأبوية في الخطاب السياسي العربي المعاصر”، وجائزة دبي الثقافية في فرع الحوار مع الغرب (الإمارات، 2008-2009) عن بحث “في كيفية الحوار مع الغرب: مدخل بلاغي تواصلي”، كما حصل كتابه “بلاغة الحرية" على جائزة أفضل كتاب عربي في العلوم الاجتماعية في معرض القاهرة الدولي للكتاب (مصر، 2013).
تقديم كتاب (ضع "رجلاك" في الطين)
المعرفة عبر الحَكي
مهمةٌ صعبة، أن أكتب تقديمًا لمثل هذا الكتاب؛ فروح "الشغف العارم" التي تحلِّق في صفحاته، لا تكاد تترك إلا شعورًا بالانبهار. شغف بفهم "تراث تليد"، واستدعاء "ذكريات طفولة"، ومحاورة "قارئ ذكي"، وتأويل "نصوص مربكة"، وصوغ عبارات متأنقة، ورسم "أشكال معبرة"، وابتكار "أفكار أصيلة". لقد أفلح مؤلِّف الكتاب، الأستاذ محمد علي مصطفى، في (خلط الطين) مثلما فعل بطل القسم الأول من كتابه، وفي (تقديم التين الشوكي مقشرًا لقارئه على طرف السكين)، مثلما فعل بطل القسم الثاني، وهو ما سوف تدركه بنفسك بمجرد أن تشرع في قراءته.
هذا كتاب عصيٌّ على التصنيف، يضرب بأقدامه في أراضي حقول معرفية شتى، أهمها: النحو، والبلاغة، وعلوم القرآن، والسيرة، والحديث الشريف، ودراسات القراءات والتأويل، والعلوم المعرفية، وعلم النفس، والأنثروبولوجيا، والتاريخ المعماري، وغيرها، لكنه قبل كل شيء، كتاب في "محبة التراث"، ومحبة القراءة، ومحبة المعرفة، ومحبة الحكي، ومحبة القارئين.
في محاولة للأخذ بيدك للولوج إلى الكتاب، دعنا نقف أمام "باب الكتاب"؛ أي: "عنوانه"، بطريقة مشابهة لتلك التي اختار المؤلِّف أن يتحدث بها إليك، عزيزي القارئ. أول ما يلقانا في عنوان الكتاب "ضَع (رجلاك) في الطين"، هو فعل أمر لمخاطب مفرد: (ضَعْ)، فاعله ضمير مستتر، تقديره (أنت). وهذا هو دأب الكاتب في هذا الكتاب الفريد. "أنت" – عزيزي القارئ – حاضر في كل سطر من سطوره، سيتحدث إليك المؤلِّف كثيرًا، يوصيك حينًا، ويستفزك بالسؤال حينًا آخر، يخدعك آنًا، ثم يكشف خدعته بعد قليل، يلقي على أسماعك بعضًا من فكاهاته للترفيه عنك، ثم ما يلبث أن يطلب رأيك فيها. يجادلك، ويسارُّك، كأنك جالس معه في حجرة واحدة طوال تأليف الكتاب. كثيرًا ما تخيلتُ أن الكاتب إنما أملى كتابه هذا على قارئه المقصود، ولم يكتبه. على الرغم من أن المؤلف نفسه يقول عكس ذلك:
«هذا الكتاب الذي هو الآن بين يديك، ربما أكون قد كتبته في الأساس للقارئ "غير المتخصص"؛ لكي أتعلم معه كيف نتأمل النصوص، وكيف نفهمها؟ وكيف نطرح الأسئلة؟! وكيف نقاوم الرتابة؟!».
ألم أقل لك: إن الكاتب إنما يتحدث إليك، بأكثر مما يكتب لك، حتى حينما يخبرنا بكتابته!
ثاني ما نلقاه في العنوان هو كلمة (رِجلاك)، مثنى (رِجل). وقد آثر المؤلف كتابتها بالألف، على خلاف القاعدة النحوية المشهورة التي تُلزم نصب المثنى بالياء؛ سعيًا في البداية وراء إثارة دهشتك، وجذبًا لاهتمامك، وحفزًا لشغفك كي تعرف سر وضع الكلمة بين قوسين، وعلة مخالفتها للقاعدة المشهورة. وحين تضع (رجلاك) في قلب الكتاب ستنتظرك المكافأة في شكل كشفٍ للعلاقة بين "رجلاك" في عنوان الكتاب و﴿إِن هَٰذَٰنِ لَسَٰحِرَٰنِ﴾ في متنه، تلك الآية الكريمة التي يستأثر بحث المؤلِّف فيها وحولها بثلثي صفحات الكتاب تقريبًا. وستعجبك في النهاية تلك اللفتة الذكية التي تربط بين التعبيرين، بعد أن يطوف بك المؤلِّف في عالم شاسع من قصص سحرة فرعون، وموسى عليه السلام، وسجالات النحاة، ومفسري القرآن، وعلماء القراءات، وأساتذة السرد الأدبي، وفناني كتابة السيناريو، وخبراء التصوير الفوتوغرافي، وغيرهم كثيرون.
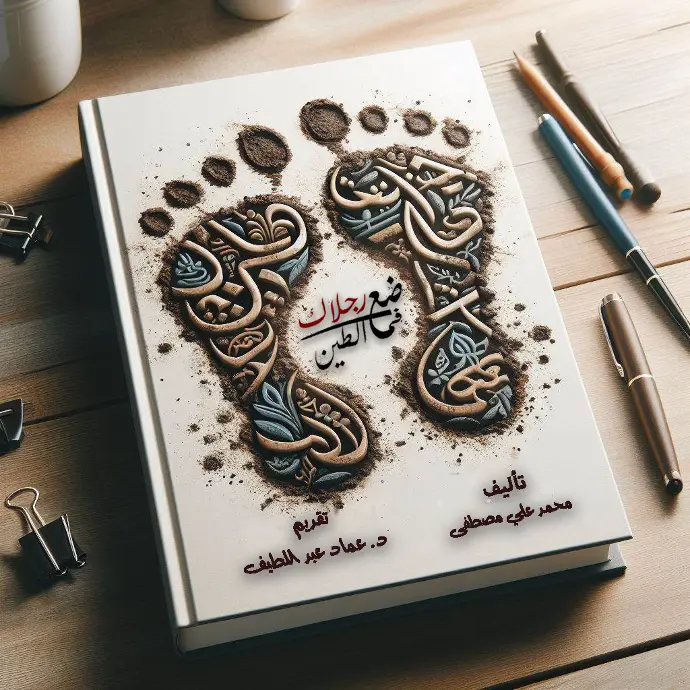
أخيرًا نأتي إلى كلمة (الطين)،
التي تكاد تكون معادلًا موضوعيًّا لحياة الإنسان: ﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ
مِن سُلَٰلَةٖ مِّن طِينٖ١٢﴾ [المؤمنون: 12]. الطين هو التجربة
والممارسة، هو الأصل والمبتدأ، هو الغاية والمنتهى (من طين الأرض ننشأ، وعليها نعيش،
وإليها نعود). قبل قراءة الكتاب لم أكن أتوقع أن تكون تجربة صنع "اللبنة الطينية"
التي بُنيت بها بيوتنا القديمة ملهمةً إلى هذا الحد. وهذه سمة أخرى من سمات العنوان،
حتى إن الكتاب كله، قد صار بمثابة تطبيق عملي لذلك، فما قد يبدو لنا في البدء فعلًا
بلا كبير معنًى (مثل أن نضع أرجلنا في الطين) يصبح - عبر مشاركة الخبرة بالقراءة -
فعلًا وجوديًّا وحياتيًّا حاسمًا، نتعلم بتأمله عن أنفسنا، وعن عالمنا الكثير بمجرد
أننا قررنا مشاركة المؤلِّف إنتاج معنى عميق لكل ما يحفل به كتابه من أفكار، وقضايا،
أو بمجرد أن نضع أرجلنا في طين كتابه الفريد، بقراءته.
تجمع حكايات هذا الكتاب المعرفية بين طريقتين في تأليفه:
الأولى: طريقة الحكاية الإطار والحكايات الفرعية التي نجدها في "ألف ليلة وليلة".
والثانية: طريقة الاستطرادات الممتعة المسهبة التي نجدها، في مؤلفات الجاحظ.
فكل فصل يتضمن حكاية معرفية إطارية، تلِد حكايات أخرى فرعية شتى. في كل حكاية من الحكايات الفرعية نجد قدرًا هائلًا من الاستطرادات المشوقة، التي يقدم فيها المؤلِّف موضوعات، أو أفكارًا، أو توصيات، أو رؤى قد تبدو، وكأنها غير وثيقة الصلة بالحكاية المعرفية الإطار، ولا الحكايات الفرعية، والتي يعرف المؤلف كيف يجمع خيوطها لك بعد حين!
ولنأخذ الفصل الأول مثالًا: الحكاية الإطار في الفصل هي قصة الصحابي الذي لا يعرفه الكثيرون منا اليوم، والذي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم، بخلط الطين اللازم لبناء المسجد النبوي.
أما الحكايا الفرعية فتشتمل على قصة حياة هذا الصحابي، ورواة أحاديثه، ومفسريها.

أما الحكايا الاستطرادية فتشمل حشدًا هائلًا من الحكايا، تمتد عبر الزمان والمكان، وتشمل حكايات أطفال القرى الذين يخلطون الطين، وقصص تشكُّل المعرفة التي تشبه بناء بيت من الطين، وحكاية بناء بيت السحيمي الأثري في القاهرة، وقصص المجازات الحقيقية واللغوية، وقصة (الحكايات) التي نصنعها لنتعلم بها ومنها، وقصة المؤلِّف نفسه مع الحكاية الإطار، وصاحب الحكاية الإطار، واستطرادات أخرى حول الكيفية التي يمكننا أن نصل بها إلى المعنى، وأن نتذوق الكلمات، وأن نطرح الأسئلة، وأن نستكشف الإجابات.
يبدو إيثار المؤلف للتعلم عبر الحكايات اختيارًا واعيًا منه، يكرره في أكثر من سياق، على نحو ما نرى في قوله:
«انحيازنا إلى جمال الحكاية، ومتعتها، والمعلومات التي تحملها، والأسلوب المغاير الذي قد يكون غير مألوف في رحلتنا خلال هذا الكتاب هو ما سوف نستثمره سوية في قراءتنا لقوله تبارك وتعالى: ﴿إِن هَٰذَٰنِ لَسَٰحِرَٰنِ﴾؛ لأن الحكاية إن بدأت تغزل خيوطها الحريرية من حولنا، فقد بدأت تغزل في وعينا منذ مئات السنين».
في سياق آخر، يحدد مؤلف الكتاب غايته من تأليفه، في فقرة استطرادية، تكاد تكون مثالًا نموذجيًّا على طريقة تأليفه، يقول:
(لعلك أن تنظر مليًّا في "الطريقة البسيطة" التي أحاول معك طيلة الوقت أن أصطنعها معك، سواء أكان ذلك في طرح الأسئلة، أم بمحاولة الإجابات عنها؛ لتعرف أن الجمال قد لا يكون بمعزل عن كل محاولة، وأنه لا تخلو المحاولات مع هذا من مخاطر، ومن مجازفات، وإثارة، ومن شوب تكلفة، ولقد يبدو لك أحيانًا في بعض الطريق أنه كان من الأفضل أن تظل «السفينة في المرفأ آمنة، لكن هذا ليس هو ما تُبنى السفن من أجله»؛ لأن تحرير الوعي، وتفهُّم الأشخاص، والمواقف يحتاج منا إلى صبر حقيقي، وإلى بذل الجهد الكافي، وإلى حس المغامرة، وإلى جرعة محسوبة من "شغف القراصنة"، فضلًا عن دهائهم، وأن الجمال لا ينبغي أن نفرضه فرضًا على النتائج، أو القناعات البحثية التي نتوصل إليها؛ حتى تكون النتائج عميقة، ومدهشة)..
«إنني أخط معك منذ بداية هذا الكتاب "خطة عمل" جمالية، وأخلاقية، لا نبتكر فيها "نموذجًا قياسيًّا" للقيم، لكن "منطلقًا" جديدًا للتأويل، دون أن أفرض عليك، أو أن تفرض عليَّ رأيًا، أو سؤالًا في غير مناسبة، أو طريقة غير ممكنة، أو غير ملهمة، أو قيمة لا تنبع من النصوص المختارة التي بين أيدينا!».
في هاتين الفقرتين، نلمس حرص الكاتب على بناء علاقة مودة بقارئه، وعلى استقلاليته في الرأي والحكم. وبفضل المنطلَقين الجمالي والأخلاقي للكتاب تمكَّن المؤلِّف من تقديم "درس استثنائي" في كيفية القراءة، والفهم، والتأويل، بل تذوق اللغة، بل وعيش الحياة، متخذًا من الحكايات المشوقة المتأملة أداته الذكية للإبحار بك في رحلة استكشاف مثرية ممتعة، تمتد، ما بين دفتي هذا الكتاب الفريد!